إيلاف من الرباط: صدر أخيرا للكاتبة والشاعرة المغربية سعاد الناصر، عن مكتبة سلمى الثقافية بتطوان، كتاب جديد بعنوان "الحركة الأدبية في تطوان / دراسة في المؤثرات النهضوية والمكونات الجمالية من 1930 الى 1970"، يستمد مشروعيته، بحسب الكاتبة، من موقع "الاهتمام بالأدب المغربي، ومحاولة إلقاء مزيد من الضوء على بعض جوانبه الراسخة تحت ركام المخطوطات أو الأوراق الصفراء"، وذلك من خلال"مساءلة الرؤية الجمالية والفكرية النابعة من النص الأدبي مدار البحث، والاستجابة لنداء الحضور التاريخي لنهضة ثقافية وأدبية رائدة وثرية نبعت في شمال المغرب،وبتطوان بصفة خاصة".

الكاتبة المغربية سعاد الناصر
وأوضحت الناصر أن دراستها،التي جاءت في 402 صفحة،موزعة على بابين من أربعة فصول،لم تأت من منطلق مغلق، وإنما لوضعها "ضمن إطارها العام في التاريخ الأدبي للمغرب،وربط شماله بجنوبه،وحاضره بماضيه دون تجزيئ متعسف،أو تصنيف ضيق"،مع تشديدها على أن هذه الدراسة جاءت من "الوعي من حجم التهميش أو التجزيئ" الذي أصاب حلقة من أهم حلقات الأدب في المغرب الحديث، جراء "عدم الإحاطة بإنتاجها الأدبي، ومكوناتها المؤثرة في نهضته وريادته، وعدم التعرض بشمولية لظواهرها الجمالية، وما أفرزته من وعي معرفي وجمالي، رهين بالتحولات الثقافية والحضارية التي شهدها المغرب ككل. وهي حلقة تكاد تكون نسيا منسيا في تاريخ الأدب المغربي الحديث والمعاصر، خاصة وأن مجموعة من النصوص الإبداعية لا تزال حبيسة المكتبات الخاصة والعامة، لم تصل إليه بعد أيدي الباحثين". لذلك شددت الباحثة على أنها كلما خاضت في موضوع بحثها زاد اقتناعها بأن البحث في الحركة الأدبية في تطوان في الفترة المدروسة، يساهم في "إيجاد الحلقة المفقودة بين الأدب القديم والجديد بالمغرب من جهة، ومن جهة أخرى يساهم في الكشف عن احتفاء حميمي ومتفرد بشروط التأسيس والتغيير والتجديد المتجذرة في التأصيل وما نتج عنه من احتضان للوعي القومي بالنهضة والإصلاح والتحديث". لذلك سعت إلى رصد الحركة الأدبية في تطوان بوصفها "صيرورة شاملة ومتداخلة من مجموع تشكلات المنجز الأدبي، وذلك في حركيتها وتطورها المعرفي والجمالي والإحاطة بالإشكالات والقضايا المتعددة والمتعلقة بمؤثرات الحركة الفكرية والأدبية، وبالمكونات الجمالية المشكلة لبنية الأجناس الأدبية، وآفاق جمالياتها، باعتبارها مجالا لتطبيقات نصية تسعف في بلورة خصائص بنائية".
وتوقفت الناصر عند مفهومي "المؤثر" و"المكون"، مشيرة إلى أن دلالاتهما تنوعت حسب الحقوق المعرفية التي تستعملهما، ويرتبطان في المجال الأدبي بالتأثيرات والإنجازات المتميزة في حقل الثقافة والأدب.وأشارت إلى أنها منذ احتضانها للمادة الخام لموضوع بحثها، وهي على يقين بأن النص الأدبي لا ينبع من فراغ، وإنما ينبت في بيئة ثقافية وفكرية تؤثر فيه، ويشكل منها قيمه وجماليته، وينفتح على آفاق إبداعية متنوعة المصادر ومختلفة النزعات.
تحديد زمني للدراسة
استدعى التحديد الزمني للدراسة، المحصور بين 1930 و1970، تقديم الكاتبة لجملة من المسوغات الإجرائية والمعيارية التي فرضت هذه الفترة التاريخية، أجملتها، أولا، في "اعتبار الثلاثينات مرحلة متميزة، سواء على الصعيد التاريخي أو الوطني، بانتهاء حركة المقاومة المسلحة، خاصة المتمثلة بالثورة الريفية التي خلقت منعطفا بارزا في تاريخ المقاومة المغربية، وخلقت تأثيرا خاصة أسهم في صياغة عقل ووجدان المنخرطين في الفعل الثقافي بصفة عامة، والأدبي خاصة. كما كان للظهير البربري وانبثاق الحركات التحررية والوطنية وما جسدته من امتداد لحركات المقاومة المسلحة، وما انغمست فيه نشاطات فكرية وثقافية.
في ثاني الاعتبارات والمسوغات الإجرائية والمعيارية، تشير الباحثة إلى أن الثلاثينيات شكلت منطلقا للحركة التعليمية الجديدة، التي كان مجالها المدارس والمعاهد، وشب في أحضانها رواد الأدب المغربي الحديث، وبداية لتكوين الجمعيات والنوادي المساهمة في النشاط الأدبي، وإرسال البعثات الطلابية إلى المشرق والغرب، الأمر الذي أسفر عن اتصال ثقافي متميز. فيما تمثل ثالث هذه الاعتبارات والمسوغات الإجرائية والمعيارية في خصوصية المواضيع والصيغ الأسلوبية التي واكبت بداية الثلاثينيات، والتي عملت على بلورة حضور ثقافي فاعل ومتميز لتطوان، بشكل أصبحت فيه من أهم المراكز الإبداعية المضيئة في المغرب؛ فضلا عن بروز نخبة من الأدباء الذين حملوا هم التحرير والتغيير والإصلاح، وعملوا، كل من رؤيته الخاصة، على خلخلة المفاهيم والبنيات الثقافية والأدبية السائدة، وإبدالها بمفاهيم وبنيات ثقافية وأدبية جديدة. وبذلك يمكن اعتبار أن الحركة الأدبية في هذه الفترة قد انبثقت عن وعي جماعي جسد مجموعة من التطلعات والأفكار والرؤى.
وفضلا عن بسطها للعوامل التي دفعتها لاختيار 1930 منطلقا لدراستها، تشدد الباحثة على أنها لم تتخفف من مرونة الرجوع إلى السنوات السابقة،كلما كانت هناك ضرورة تاريخية أو أدبية تحتم ذلك. أما الوقوف عند 1970 فقد فرضته اعتبارات تاريخية وأدبية، أيضا، منها خروج الاستعمار من المغرب وما خلفه من توقف مع الذات والآخر، وما نتج عن هذا التوقف من صمت عدد من الأقلام التي كانت ترى للأدب وظيفة معينة، وما تلا ذلك من إطفاء ونسيان للمشعل النهضوي، خاصة في مجال الأدب، الذي حملته تطوان، ولم تعد تذكر إلا بشكل عابر من باب التأريخ فقط. ثم صدمة هزيمة 1967التي خلفت شرخا عميقا في وجدان المثقف والأديب المغربي بصفة عامة، وخلقت نوعا من عدم جدوى الأدب.ناهيك عن تداعيات موضوع فرض اللغة الفرنسية بشكل مباغت على أبناء تطوان المتشبعين باللغة الإسبانية، وما سببه ذلك من عثرات أدت إلى توقف الازدهار الأدبي في هذا الوقت مقارنة بالفترة السابقة.
كما شكلت نهاية الستينيات وبداية السبعينيات بداية مرحلة جديدة متميزة في التجريب الشعري واكتمال بعض الأشكال السردية في المغرب ككل، الأمر الذي يجعل من التحديد الزمني (1930 – 1970) ضرورة ملحة تعتبر هذه الفترة حلقة متفردة من حلقات الأدب المغربي الحديث، تربط السابق باللاحق، وتساهم بفتح آفاق الإبداع المغربي، وبصمه بالطابع المغربي الخاص.
تأمل النصوص الأدبية
انطلاقا من التأمل في النصوص الأدبية بشكل عام ، تبينت للباحثة العلاقة الجدلية القائمة بين هذه النصوص والأحداث السياسية والاجتماعية، والتحولات والتغيرات التي اعترتها من حيث الإطار العام الذي تحددت فيه، والسمات البارزة التي اصطبغت بها، خاصة توحدها مع العمل الوطني الذي انطلقت فيه من وعي عال بالنهضة، والتزام بقيم الحرية والإصلاح.
وانطلاقا من امتزاج الروح الوطنية بالروح الإبداعية الذي كان له أثر كبير على الساحة الأدبية، كان لا بد من النظر إلى النص الأدبي من خلال مجالين اثنين، أولهما يروم التركيز على فعل الكتابة في حد ذاتها، باعتبارها بنية نصية،تتكون من نصوص إبداعية لها سماتها المميزة، في إطار الجنس الأدبي الذي تنتمي إليه؛ فيما يهدف ثانيهما إلى وضع النص في أبعاده الثقافية والاجتماعية والسياسية، واستشراف سياقاته الفكرية، ومنعطفاته المعرفية، ومجالات وظيفته الأساس في تكثيف الوعي الإنساني لمعرفة العالم.
اختيار منهجي
وضعت غزارة المادة الأدبية - وطبيعتها المتنوعة، ومحاولة تقصيها في منعرجاتها المنشورة ومخطوطاتها المتناثرة - الباحثة، إزاء خيار التصنيف، ثم انتقاء نصوص ونماذج تمثيلية تبرهن على النتائج التي توصلت إليها. فيما لم يكن الغرض، تضيف الباحثة، تحصيل نتائج مسبقة، وإنما وضع اختيار منهجي يراهن، أولا، على وصف الظاهرة الأدبية والتأريخ لها، واستكشاف العلاقات المكونة لها بالغوص في دواخلها، مراعية في ذلك المرجعية التي أنجبتها، وكان لها تأثير مباشر في تشكيل الحركة الأدبية بتطوان، والوعي الحضاري المصاحب لها، ورصد السياقات المختلفة المتفاعلة، اجتماعية وثقافية وتاريخية إبان مرحلة البحث، التي كان لها تأثير فعلي في بزوغ البذرات المتمخضة عن الفعل الأدبي والثقافي الحديث.
كما راهن الاختيار المنهجي، ثانيا، على اقتراح مقاربة تحليلية تبحث في الدلالات والأشكال، وتستنطقها اعتمادا على نتائج بعض الدراسات النقدية والبلاغية المعاصرة، دون التخلي في كل الأحوال عن إرهاف السمع لنبضات النص واستكشاف خصائصه البنائية.
بالنسبة للباحثة الناصر ، يسعف الاختيار المنهجي، الوصفي والتأريخي والتحليلي، في مساءلة النص الأدبي في مبناه ومعناه، والإحاطة بجوانبه بشمولية وعمق، من أجل الوصول إلى الإفادة، والمساهمة في إضافة لبنة علمية جادة في البناء الفكري والأدبي الإنساني بصفة عامة.
تساؤلات
تساءلت الباحثة الناصر في "إضاءة" كتابها عن المؤثرات التي بلورت الوعي الحضاري عند الأديب، وعملت على تطوره ونضجه في إطار منظومة الإصلاح والتغيير والتحديث، وكان لها تأثير مباشر على الحركة الأدبية في تطوان. كما تساءلت عن المكونات الجمالية التي تكونت منها الأجناس الأدبية، سواء السائدة في البيئة الثقافية، أم الحديثة، الوافدة عليها، والمنصهرة فيها.
ومن خلال إثارة مثل هذه التساؤلات، تقول الباحثة، "ندرك بأن مصطلح الوعي الحضاري هو مفتاح الدراسة، وذلك بوصفه البصمة التي طبعت بدايات التحديث في الحركة الأدبية في تطوان منذ بداية ثلاثيات القرن الماضي".
وعي حضاري
تطرقت الباحثة الناصر ، في مدخل كتابها، إلى الظروف الاجتماعية والسياسية التي كانت تعيشها مدينة تطوان أوائل القرن العشرين، وقالت إنها كانت في حالة تأهب مستمر، واستنفار واضح نتج عن الهيمنة الاستعمارية، وتطلع أفراد المجتمع إلى تحرير الوطن. فيما سبق العمل الجهادي واستصحبه بعض بوادر الوعي الحضاري الذي حمل بين جنباته مفاهيم سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية،أخذت تتطور وترتقي من أجل تكوين أجيال مغربية جديدة قادرة على المواجهة والتحرر وتحقيق الذات.وتجلت هذه البوادر أكثر حين أخمدت الحركة الجهادية في نواحي تطوان ، ببروز صفوة من مثقفي المدينة حاولت تلمس أسباب الهزيمة، ورأت أن الجهل والتخلف والأمية وشيوع الفكر الخرافي من أهم أسبابها، ولذلك كان التفكير في تجاوزها بالتنادي بالإصلاح والتغيير في مختلف الميادين، وإثبات الهوية منذ العشرينيات، مما كان له تأثير مباشر على الحركة الأدبية. وبالنسبة للباحثة الناصر ، يمكن استجلاء بدايات هذا الوعي في تأسيس المجمع العلمي المغربي في 1916؛ وتأسيس المدرسة الأهلية سنة 1925، وهي أول مدرسة مغربية وطنية حرة؛ وتأسيس أول جمعية سياسية بتطوان، سمت نفسها العصبة المغربية، برئاسة عبد السلام بنونة في 1926، تضم خيرة الشباب المثقف الداعي إلى الوطنية والنضال؛ وتأسيس المطبعة المهدية سنة 1928، التي فتحت آفاق الاتصال بين المثقفين والأدباء وبين عامة الشعب، كما ساهمت في طبع العديد من الكتب العربية والمغربية والمجلات والصحف، التي كانت من مراجع المثقف آنذاك؛ وتكثيف الاتصال الثقافي بين المشرق والمغرب، سواء عن طريق البعثات الدراسية، أو عن طريق الكتب الوافدة؛ ليشكل كل هذا، بداية النضال السياسي والاجتماعي والاقتصادي وانبثاق الحركة الوطنية، مما انعكس على البنية الثقافية المغربية ككل، وفتح المجال لشق قنوات جديدة فيها.
وترى الباحثة الناصر أن هذه المرحلة التاريخية، بكل ما يطبعها من تحولات على جميع المستويات، كانت تسعى إلى محاولة تأسيس بنى جديدة من خلال البحث عن هويتها الحضارية الأصلية للانطلاق منها إلى تحديد موقعها في عالم المعاصرة والتحديث. الأمر الذي يعني أن "التحديث والتجديد في الأدب لم يكن مجرد تحول في الأشكال الأدبية التي كانت سائدة، بل كانت تعبر عن ضرورة اجتماعية وثقافية، مستوحاة من الواقع المتجدد بفضل تأثيرات مختلفة، لعل أهمها الانفتاح على الآخر، الشيء الذي جعلها تعبر عن وعي حضاري بارز، وصياغة لرؤية جديدة للإنسان والواقع والكون".
خلاصات
بسطت الباحثة الناصر في خاتمة كتابها ست ملاحظات، مشيرة في أولاها إلى أن الكتابة الأدبية والثقافية بصفة عامة في تطوان كانت محاولة مستمرة للانفلات من هيمنة المؤسسات الثقافية الرسمية وخرق الحصار المضروب حول حرية التعبير، ومعانقة دؤوبة للطموح المعرفي والحضاري، الأمر الذي أفرز بنيات ثقافية متجددة ومتنوعة. ومن هنا، كان السؤال الرئيس الذي تمركز حوله الإنتاج الثقافي والأدبي يهم كيفية ولوج الحضارة الحديثة، ووضع الأدب المغربي بجوار الآداب العالمية.
وكتبت الباحثة، في ثاني ملاحظاتها، أن هذه الحركة تمثل حلقة وصل لا غنى عنها في ربط عصر النهضة بما يعرف الآن بالحداثة، حيث لا يمكن الحديث عن الأدب المغربي دون الوقوف عندها وعند أعلامها البارزين الذين طوتهم يد النسيان تحت ركام الأوراق الصفراء، رغم أنهم يشكلون علامة مضيئة في تاريخ الأدب الحديث بالمغرب، وبداية الدعوة إلى جمالية الأدب بوصفه استراتيجية للوعي الوطني والقومي، ومظهرا من مظاهر التعبير والإصلاح.
أما ثالث الملاحظات، فتتمثل في اعتبار الذاكرة الشعرية مرجعا لا غنى عنه في تهذيب الذوق العام مع الانفتاح المشروط على المرجعيات الحديثة الوافدة. أما الملاحظة الرابعة فتتعلق بولوج مجموعة من الشباب بوابة التحديث الشعري معانقين النفس الرومانسي، فتكونت لديهم رؤى خاصة حول الحرية والخيال الأمر الذي يستوجب إعادة تأمل مدى حضورهم في فضاء الشعر المغربي الحديث، وهو ولوج طرح بشدة مسألة الجديد والقديم، وأبرز سمة الإبداعية التي حملت في طياتها بذور التجديد إن على مستوى التقليد أو على مستوى التحديث.
أما في الملاحظة الخامسة فيظهر أن عدم وضع القصة في تطوان في سياقها الوطني قد لا يفضي إلى نتائج سليمة عند دراسة القصة في المغرب. فيما ركزت الملاحظة السادسة على الرسالة التي عرفت تعددا في المواضيع وامتدادا للرسالة المغربية والأندلسية، لكن مع تخلص الكتابة من النمط التقليدي، ستعرف الرسالة تحولا جذريا في بنيتها، بشكل مكنها من التخلص مما كان يثقل كاهلها من ألوان التزين.
في ختام دراستها، تخلص الكاتبة الناصر ، من باب الإخلاص لفضيلة التواضع المفترض في الباحثين، إلى أن دراستها خطوات في طريق ما سمته بـ"الثراء الأدبي المنسي"، الذي "يحتاج إلى عدة قراءات، ترمم ما اعترى البحث من هفوات وتقصير".
سيرة
سبق للناصر أن أصدرت، منذ 1986، دواوين شعرية، منها "فصول من موعد الجمر"، و"سأسميك سنبلة"، و"هل أتاك حديث أندلس". كما صدرت لها كتابات سردية بينها "إيقاعات في قلب الزمن" و"ظلال وارفة"، و"في معراج الشوق أرتقي"، و"كأنها ظله"، مع تحقيقها للرحلة التي قام بها الشيخ محمد الصفار من تطوان إلى باريس، بعنوان "الرحلة التطوانية إلى الديار الفرنسية".
كما أصدرت الناصر، الحاصلة على الدكتوراه سنة 2003، مؤلفات ودراسات أخرى، بينها "بوح الأنوثة"، و"قضية المرأة: رؤية تأصيلية"، و"زاد المرتحل"، و"الدعاء"، و"نساء في دائرة العطاء"، و"بلاغة القص في القرآن الكريم"، و"توسمات جارحة"، و"التخييل الروائي العربي للعنف والمقاومة"، و"السرد النسائي العربي بين قلق السؤال وغواية الحكي".


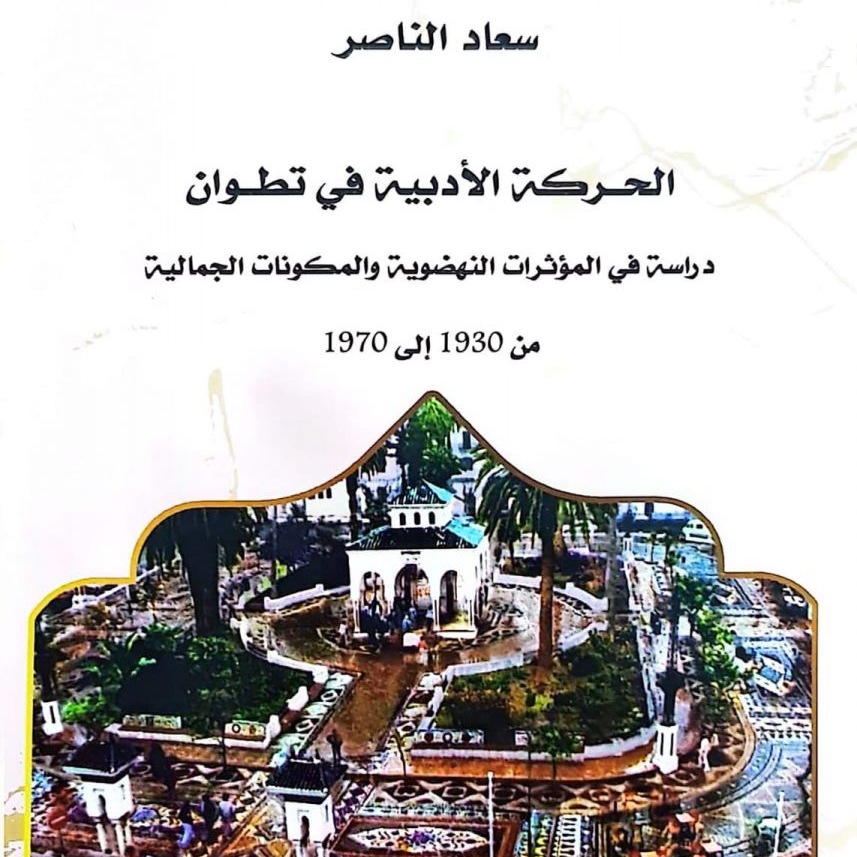










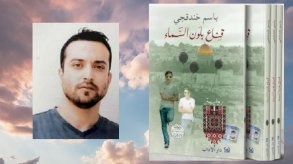
التعليقات