&زهير الحارثي
&من المهم تعويد الذات على الحوار، والإصغاء، واحترام الرأي المخالف مهما كانت النزعة والاتجاه والمضمون، ما يقتضي من العرب القيام بحركة نقد معرفية كبيرة للثقافة والعقل، تحدد من جديد تلك العلاقات التي تربطهم بأنفسهم وبالعالم من حولهم، فالدور للعقل وليس للعاطفة..
الحوار ظاهرة صحية، ومطلب أساس لحياتنا، وجسر للتواصل الإنساني والإثراء والتفاعل بين كل فئات المجتمع؛ بشرط قبوله كما هو، لا كما يراد له أن يكون، مع الأخذ في الحسبان أن أزمته ستبقى قائمة ما لم ترتكز على الانفتاح على الآخر. ولعل الثقافة الأحادية، كما نشهدها في كثير من بلداننا العربية، يتولد عنها جو من الاختناق، وبالتالي فالمصير هو حواجز واصطدام ودفع أثمان مكلفة ما كان لها لتحدث في بعض الدول العربية الآن لو ارتهنت للحوار.
بعد رحيل الاستعمار عن بعض الدول العربية، نشأت أنظمة وطنية، وأطلقت شعارات مؤثرة آنذاك؛ لارتباطها بالاستقلال والأرض والحرية والكرامة، إلا أنها سرعان ما عادت إلى ممارسة القمع الاستعماري ذاته، بمجيء أنظمة عسكرية كرست الاستبداد والديكتاتورية. تحول المشهد من ليبيرالية مشوهة بعد الاستقلال إلى فضاء ملوث بالعنصرية والتمييز المذهبي والطائفي.
لم يعد للمواطنة والحوار والتعايش حيز، بل أصبحت ساحات بعض الدول ميداناً لاشتباكات أهلية وطائفية وتعصب وانغلاق وتخلف وجهل. صحيح أن العرب آنذاك كانوا قد تخلصوا من الاستعمار، إلا أنهم ارتهنوا له مرة أخرى بصيغ وأشكال مختلفة وربما أشد وطأة. والمثير للدهشة أن هذا السيناريو لا يتوارى عن المشهد العربي، فتراه يطفو على السطح بين حين وآخر.
غياب دولة القانون والمواطنة وضمانات حقوق الإنسان واحترام الدستور من الأسباب التي أسهمت في افتقار العرب عمليا إلى السيادة سياسيا واقتصاديا، ولا سيما في وقتنا العولمي الراهن، الذي أصبح بمنزلة عالم للتكتلات، وإذا ما أخضعنا هذه الحالة المأسوية لمنهج الملاحظة، فسنجد أن أهم أسبابها هو غياب الحوار، والخشية من التعددية؛ وهي مسؤولية مشتركة ما بين الأنظمة الحاكمة وشعوبها.
على أي حال، تلك سمة تمتاز بها العقلية العربية، التي عادة ما تنزع إلى الرأي الأحادي، الذي يتوافق مع رغباتها وأهوائها، وفي كل مجتمعاتنا العربية شرائح من تلك الفئة تصر على صحة آرائها، بل إنها لا تلبث أن تقف موقف الرفض أو التشكيك إزاء الرأي الآخر، لأنها ترى فيه تهديدا لمصالحها أو منافعها أو حزبها أو سلطتها، ولعل التاريخ في عمره المديد يضم في جعبته كثيرا من هذه الحقائق والغايات، التي تجسدت في مؤامرات وتصفيات جسدية وانقلابات عسكرية لا تلبث أن تعود بين حين وآخر.
سلبية ونكوص يصيبان الإنسان العربي بعدم القدرة على التفكير، فلا يلبث أن ينعزل لشعوره بعدم أهميته، وقد يمارس نفي (الآخر) بكشف العيوب، والتركيز على النواقص والتهاجي. هذه ممارسات تعكس واقعا ماثلا في الشارع العربي، وتلمس سوء التواصل، سواء بين الأفراد أنفسهم، أو بينهم وبين الحكومات والمؤسسات الاجتماعية، التي تأخذ أشكالا متعددة منها السخرية والاستخفاف.
يقول د. جاب الله موسى "الإنسان العربي يشكل لنفسه آلية رفض خاصة به، تحقق له التوازن النفسي مع نفسه ومع الآخر بأقل قدر من الخسائر في بيئته الاجتماعية، تلك الآلية هي التكور على النفس أحيانا، والنفاق أحيانا أخرى، الذي أصبح جزءا مكونا لشخصيته لدرجة صعوبة فصله كسلوك طارئ"، ولعل من يرصد السلوكيات اليومية التي يمارسها المواطن العربي في يومه المعاش، يجد فيما ذكر آنفا كثيرا من الصحة.
أتصور بوصفي متأملا للمشهد، أن كسر تلك الحالة التكورية - إن جاز التعبير - يكمن في الحوار والانفتاح والشفافية. الحوار هو الأساس في أي مشروع ثقافي أو طرح فكري؛ كونه يفرز عادة مواقف متباينة، ما يثري النقاش، ويفتح المجال للآراء المتنوعة، إلا أن البعض يجعل منه فرصة للسيطرة والتباهي؛ كونه لا يستسيغ الفكر المخالف لرؤيته، أو الطرح المتعارض لتوجهه، وكأن له إطارا محددا لا يسمح بتجاوزه، وهذه الفئة وإن كانت لا تعبر عن السلوك السائد للمجتمع، إلا أنها تبقى جزءاً من نسيجه ومؤثرة في سلوكه الجمعي.
من المهم تعويد الذات على الحوار، والإصغاء، واحترام الرأي المخالف مهما كانت النزعة والاتجاه والمضمون، ما يقتضي من العرب القيام بحركة نقد معرفية كبيرة للثقافة والعقل، تحدد من جديد تلك العلاقات التي تربطهم بأنفسهم وبالعالم من حولهم، فالدور للعقل وليس للعاطفة.






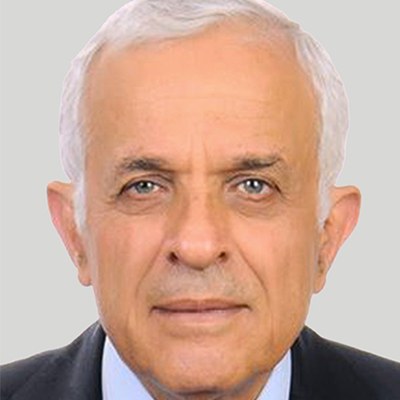













التعليقات